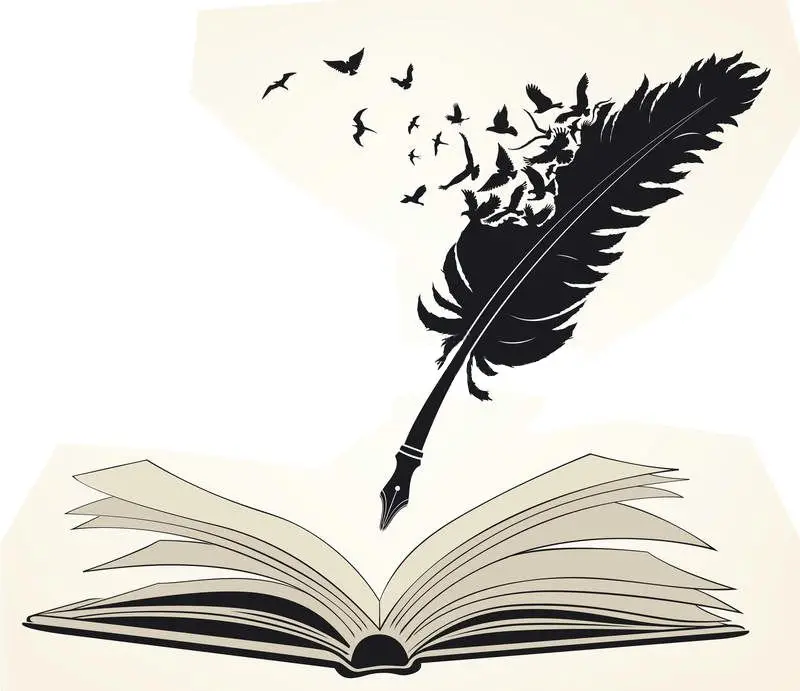Table of Contents
محمد التاودي
الكتابة فعل مقاومة… ليس بالضجيج بل بالإصرار على المعنى.
ولعلّ البداية كانت دائمًا هناك، حيث الكلمة ليست زينة، ولا الحبر مجدًا، بل نداء داخليّ، صامت في ظاهره، عنيف في جوهره، يشبه ذلك الأنين الخافت الذي لا يُسمع، لكنه يُوقظ الحجارة في أعماقنا.
كانت الكتابة، منذ ولادتها الأولى، فعلًا فطريًا يشبه النجاة من الغرق دون أن يلاحظ أحد ذلك. ليست مهنةً، ولا ترفًا فكريًّا، بل حاجةٌ وجوديّةٌ مُلِحّة، لا يهدأ صاحبُها إلا إذا كتب.
مع مرور الوقت وزيادة ضجيج العالم، ازدادت الحاجة إلى الكتابة، خاصة حين تختنق الأصوات في زحام التفاصيل، ويصبح الصمت أثقل من الكلام، فلا يبقى لنا سوى أن نكتب.
الكتابة كضرورة وجودية
نكتب… لأن الصمت مريرٌ ولا يُحتمل، وليس لأننا نملك الحقيقة، بل لأننا لا نقوى على احتماله. فالكلمة الصادقة هي شعلتنا الصغيرة التي تُقاوم الزيف، وتنير درب المعنى في عتمة العالم.
وقد قال كارلوس فوينتس: «الكتابة هي الشيء الوحيد الذي يجعل العالم يحتمل القليل من المعنى».
الكتابة كملاذ من صخب المعنى
حين يعجز العالم عن احتضان أرواحنا، نطرق باب الكتابة لنتنفس ونمضي.
فالكتابة ليست مجرد مهارةٍ نُتقنها، بل ملاذٌ نلوذ به، مأوى نختبئ فيه من صخبٍ يخنقُ المعنى.
هي الترجمة الوحيدة الممكنة لما لا يُقال، والصوت الخافت القادر على التسلّل من بين شقوق الجدران السميكة.
مقاومةٌ ناعمة،لا تُحدث ضجيجًا، لكنها تهزّ جدار الصمت من الداخل.
الكتابة… وجه آخر للحياة
ولأن هذه المقاومة لا تحتاج إلى لافتات، بل إلى صدقٍ عارٍ، فالكتابة… وجهٌ آخر للحياة.
ثمّة من يكتب لأنه عاش ما لا يُروى، وحين عجز عن أن يجد من يُصغي، قرّر أن يُنصت إلى نفسه. لا يبحث عن جمهور، بل عن معنى. يكتب لا ليُدهش، بل ليُضمد.
هو يعلم أن الحروف لا تُغيّر العالم دفعةً واحدة، لكنها تُغيّر شيئًا صغيرًا في داخله… في كل مرة يُمسك فيها القلم، يُزيح قليلًا من الركام عن ذاكرته.
أما الذين يكتبون في الظل، فلا يبحثون عن الأضواء، بل عن عمقٍ يتوارى خلف الظاهر.
فهم لا يعتلون المنصّات، ولا يظهرون في المهرجانات. يكتبون في العتمة، لأن النور لا يُكتب، بل يُشتاق إليه.
يكتبون كما يُصلّي الحالمون: بخشوعٍ وأمل. لا يكتبون من أجل المجد، بل من أجل النجاة.
الكتابة كعملية مساءلة وتأمل
الكتابة هنا ليست مجرد أداةٍ للتعبير، بل مرآةٌ للذات وهي تتفكك وتُعاد صياغتها.
حين تكتب الذات لتفكك ما فُرض عليها. الكتابة، في جوهرها، ليست تطريبًا للغة، بل مساءلةً لها.
ليست وصفًا للواقع، بل شكًّا فيه. ليست سردًا للوقائع، بل تفكيكًا لما تحتها من صمت.
لكنها ليست مساءلةً للغة فحسب، بل تفجيرًا لأسئلتها الكامنة، وإعادةَ ترتيبٍ لما نعتقد أننا. نفهمه.
تمامًا كما يمكن للكلمة أن تتحوّل من يقينٍ بسيط إلى متاهةٍ من الدلالات، تتحوّل من مفهومٍ مألوف إلى شعورٍ لا يُختزل، ومن شعارٍ مكرور إلى شجنٍ يتخفّى في تفاصيل الذاكرة.
الكتابة تصبح سؤالا مفتوحا
حين تُكتب الكلمة بصدق، لا تعود إجابةً جاهزة، بل تُصبح سؤالًا مفتوحًا، ومساحةً للتيه والتأمل.
فالكتابة الحقيقية لا تُكرّر ما قيل، بل تحفر في المسكوت عنه، وتُعيد ترتيب الحكاية من موقع المختلف، لا من موقع التابع.
إنها ليست نسخًا لما كان، بل تشريحًا لما نعتقد أننا نعرفه، وبحثًا مستمرًا عن نبرةٍ لم يُجرّبها أحدٌ من قبل.
صدى الكلمات في عصر الصور
في زمنٍ تغلب فيه الصور على المعاني، تظلّ الكتابة محاولةً لصون جوهر الكلمة، وإن كان العالم يختزلها في ومضات رقمية سريعة.
أما الذين كتبوا من الأعماق، فيغدون اليوم مرايا تُواجه زمنًا يختزل الكلمة في ومضة؛ عصرٌ تُقاس فيه المعاني بعدد الإعجابات، وتتحوّل فيه اللغة إلى ظلٍّ عابر، والصوت إلى صدى مستعجل.
الكلمة الصادقة كالنبتة الشوكية
لكنْ، في خضمّ هذا كلّه، تظلّ الكلمةُ الصادقة كالنبتةِ الشوكيّة: تنمو بين الصخور، لا تنتظر إعجابًا، ولا تلهث خلف الضوء؛ يكفيها أن تُوقظ شرخًا في وعي قارئٍ واحد.
ذاكرة الجسد: من الألم إلى الفن
أليست ذاكرة الجسد مثالًا حيًّا على كيف للكلمة أن تُحوِّل الزمنَ من عدوٍّ إلى حليف،
وأن تُنضج الألمَ وتحوّله إلى فنٍّ يقاوم التبديد؟
ففي كلِّ جملةٍ موجعةٍ صدقٌ يُقاوم المحو، وفي كلّ وصفٍ للجُرح بُرهانٌ على أن المعاناة لا تموت إذا كُتبت.
الكاتب الحقيقي: من يُربك لا من يُطمئن
كلُّ نصٍّ، في حقيقته، مقاومةٌ ناعمة ضد القالب، ضد اللغة الجاهزة، ضد المفاهيم المعلّبة، وضد الجمال المصنّع.
الكاتب الحقيقي لا يكتب ليُرضي، بل ليُربك؛ لا ليطمئن القارئ، بل ليوقظه.
هو يعيد ترتيب الأشياء من الداخل، ويمنح اللغة اهتزازها الأول، قبل أن تُهذّبها القواعد.
حين تصبح اللغة وطنًا مؤقتًا
حين تتشظّى الهويّات، تصبح الحروفُ وطنًا مؤقّتًا، شرفةً نطلّ منها على مدننا الداخليّة.
وفي لحظة صدق، تتساءل الكتابة عن ذاتها: لمن ننتمي؟ لأيّ ذاكرة؟ لأيّ جُرح؟
تُدرك أن الهويّة ليست بيتًا من طينٍ واحد، بل نسيجًا من تناقضات.
وحين تكتب الذات، لا تبحث عن نقائها، بل عن تشظّيها. لا تُجمّل ماضيها، بل تعيد حياكته بخيوطٍ من أسئلة؛ خيوطٍ لا تُخاط، بل تكشف ما كان يُراد له أن يُنسى.
الكتابة… منفى جميل للهوية المركّبة
حين تتنازعك لغاتٌ وانتماءات، وتتجاذبك أكثر من هويّة، تصبح الحروفُ منفىً جميلًا لترويض التمزّق، لا لتكريسه.
في لحظات الضياع، تُبنى خرائط داخليّة لا لتحديد الاتجاه، بل لرفض الاختزال في جهةٍ واحدة أو اسمٍ واحد.
فأنت لستَ ابنَ أرضٍ فقط، بل ابنُ أسئلةٍ لا تنتهي، وابنُ منافٍ لم تخترها، وصمتٍ لم تُفسّره بعد.
واللغة، مهما بدت مألوفة أو غريبة، ليست سوى محاولة لبناء جسر بين أعماقك وعالَمٍ قد لا يفهم منك إلّا ظلَّ الحقيقة.
الكتابة كمعركة
“الكتابة ليست مهنة، إنها معركة.”
هكذا وصف الشاعر الفلسطيني محمود درويش مسيرته الأدبيّة، حيث جعل من الكلمة سلاحًا حادًّا يقاتل به ضد السطحيّة والتهميش والنسيان.
كتب درويش باندفاعٍ مماثلٍ لمن يُشعل النار في فراغ الحياة، لا من أجل التصفيق أو الشهرة، بل بحثًا عن شرارةٍ تنقذه من صمت العالم.
وعندما رحل، لم تُغلق دفاتره، بل بقيت مفتوحة كجُرحٍ نبيلٍ يهمس لمن يأتي بعده: إنّ الكتابة الحقيقية، حين تكون صادقة، لا تنتهي عند آخر سطر، بل تبدأ من حيث يصمت الجميع.
الكتابة ضد النسيان
كم من ذاكرةٍ اندثرت لأنها لم تجد من يكتبها؟ كم من وجعٍ تاه في الزحام لأنه لم يتحوّل إلى سطر؟
الكتابة الحقيقية لا تُنقذ أصحابها فقط، بل تُنقذ الأرواح التي لم تجد وسيلةً للبوح. إنها ليست فعل تذكّر، بل تمرّدٌ على النسيان.
وحين يكتب المرء عن الهامشيّ، عن المهزوم، عن المهمَّش، فإنه لا يمنحه مجدًا، بل اعترافًا. يُعيد إليه اسمه، صوته، صورته.
ولذلك، لا تُقاس عظمة الكتابة بعدد الجوائز، بل بعدد الأرواح التي مستها، والوجوه التي أعادت إليها المعنى.
في وجه الإعصار الرقمي
ولئن كانت الكتابة ملاذًا من صخب الذات، فقد صارت اليوم تُواجه صخبًا أعتى: زمنًا رقميًا يُحوّل الكلمات إلى ظلالٍ عابرة، والعمق إلى ومضة.
في زمنٍ تُقاس فيه الكلمات بعدد الإعجابات، وتُختزل المعاني في رموزٍ مبتسرة، باتت الكتابة تخوض اختبارًا عسيرًا.
لم نعد نقرأ النص، بل العنوان. لم نعد نستمع إلى الفكر، بل إلى الإيقاع.
تراجعت الكلمة أمام سطوة الصورة، وتحوّلت إلى ملحقٍ في زمن العروض، وصار الكاتب كمن يُنادي في صحراء ممتدة… بلا صدى.
وعندما تكون الكتابة بهذا القدر من الصدق، تتحوّل إلى فعلٍ جريء لا يعرف التزييف.
من هامش الألم إلى نور الكتابة
وهكذا، حين تكون الكتابة وفاءً للحقيقة لا تزييفًا لها، يصبح الحبرُ شكلًا من أشكال الجرأة.
فمحمد شكري، في الخبز الحافي، لم يكتب من برج اللغة، بل من قاع التجربة.
كتب بلغةِ العظم الجافّ، لا ليُزيّن الواقع، بل ليكسر أسنانه على قسوته.
كأن كلماتِه تمشي حافية، كما عاش هو، بلا أقنعة، بلا مجاملة، وبلا خوفٍ من العراء.
معركة الكلمة في الزمن الحديث
ومن قلب هذه التجارب العميقة، نُدرك أن المعركة الحقيقية، في زمن السطحيّة والانتباه المبعثر، لا تُخاض بالصوت المرتفع، بل بالكلمة التي تحفر طريقها في الصمت.
ولعلّ محمد خير الدين، الذي ظلّ وفيًا لحرارة الورق رغم ضجيج التحوّلات، لخّص هذه المعركة بقوله:
“الكتابة ليست صدىً لما يحدث، بل ما يجب أن يُقال حين يصمت الجميع.”
كلماتٌ تمشي الهوينى في زمنٍ يركض؛ تذكيرٌ بأنّ العمق لا يُولد من التفاعل اللحظي، بل من صمتٍ يُنبت المعنى كما تُنبت الأرضُ عُشبها في خفاء.
كتابة النساء: صوت مقاوم من هامش مضاعف
إذا كان الرجال قد كتبوا من قاع التجربة، فإنّ النساء كتبن من هامشٍ مضاعف، حيث كان الحبر سلاحًا لمقاومة المحو والتهميش.
فالكاتبة المغربية الراحلة فاطمة المرنيسي، من خلال كتابها الحريم السياسي، كسرت صمت الجسد الأنثوي، وأكّدت أن الكتابة هي سلاح المهمَّشين في مواجهة طمس التاريخ. قالت: “الكتابة هي المكان الذي تستعيد فيه المرأة صوتها، وتعيد صياغة قصتها بيدها”
الكتابة كفعل استرداد لا شكوى
ولأنّ التجربة الأنثوية لا تُروى إلا من داخلها، جاءت كتابة النساء كفعلِ استرداد، لا شكوى.
لم تكن مجرّد استعراضٍ للخراب، بل استعادةً لما سُرق منهن في الطفولة، والفقر، والتهميش، والقيود المفروضة على الجسد والعقل.
ولأنهن كتبن لا لإرضاء الذائقة، بل لإسكات الصمت، جاءت لغتهن جافةً كالعظم، جارحةً كحقيقةٍ لا يريد أحدٌ سماعها.
مواجهة الواقع بلا أقنعة
وهنا يبرز التحوّل الجوهري: لم تكتب المرأة لتُجمّل الواقع أو تتودد للقارئ، بل واجهته بالحياة كما عاشتها، بلا أقنعة، بلا تزييف، بلا رتوش.
وحين سُئلت إحداهن عن سبب كتابتها، أجابت ببساطةٍ مؤلمة: “لكي لا أُجن.”
بهذه الصرخة، تحوّلت الكتابة من وسيلةٍ للتعبير إلى وسيلةٍ للبقاء… من فعلٍ أدبيٍّ إلى ضرورةٍ وجوديةٍ لا مفرّ منها.
من الشهادة الصامتة إلى الفاعل التاريخي
ومع هذا التحوّل، لم تعد المرأة الكاتبة شاهدةً صامتةً على مجريات التاريخ، بل فاعلة تُعيد كتابته من جديد.
في ثلاثية غرناطة، لم تكتب رضوى عاشور عن النساء بوصفهن ضحايا، بل فسحت لهن المجال ليكنّ مركز الحكاية، لا هامشها.
إنّ الكلمة، حين تخرج من جُرحٍ أنثويٍّ واعٍ، لا تُطالب فقط بإنصافٍ مؤجَّل، بل تُعيد رسم معنى الإنسان من الأساس.
مشروع التحرر: من سجن الجسد إلى حبر المقاومة
ومن هذا الجرح العميق، يتكامل الخطّ التحرّري في مشروع نوال السعداوي، التي حوّلت الجسد الأنثوي من سجنٍ رمزيّ إلى ساحةِ معركةٍ بالحبر.
لم تكتب لتستعطف، بل لتكسر الصمت. لم تكتب من أجل البكاء، بل من أجل انتزاع حقّ الوجود.
الكتابة بين السلطة والرغبة
وتتّضح ملامح هذا المشروع أكثر حين نفهم أن الكتابة لا تعود فعلًا أدبيًا بحتًا، بل حقلَ نزاعٍ مفتوح بين السلطة والرغبة، بين ما يُراد للمرأة أن تكونه، وما تختار هي أن تكونه.
“الحرية لا تُمنح، بل تُنتزع بالحبر”… هكذا ظلّت كتابتهن فعلًا مستمرًّا في زلزلة البديهي وتفكيك الموروث.
سكون اللغة وسط الزحام
في خضمّ هذا الصراع، من يعرف أن يسكن لغته، سيجد طريقه وسط هذا الزحام، لأن الكلمة الصادقة، ولو نُشرت بين آلاف الصور والفيديوهات، تظلّ تطرق قلب من يبحث عنها… بهدوء، وبلا إعلان.
خشوع المعنى في محراب اللغة
الكتابة، من هذا الأفق، تبدو كأنها صلاة على ورق، لا تستعجل الوصول، بل تطلب البقاء.
هكذا ظلّ محمد خير الدين يحفر بلغته طريقًا نحو القارئ المتأمّل، يؤمن أن الصمت لا يُكسر إلا بما يُكتب بصدق، لا بما يُنشر كثيرًا.
مرآةٌ للنفس ومسارٌ للتحوّل
الكتابة ليست مجرّد تعبير عن الذات، بل هي عملية تحوّل خفيّة تبدأ من الداخل وتفيض إلى الخارج.
إنها تعيد ترتيب الفوضى الداخلية، تمنح الألم شكلاً يمكن احتواؤه، وتحوّل التجربة الشخصية إلى وعيٍ قابل للمشاركة.
بذلك، تُربّي في النفس القدرة على التأمّل، وتُعلّمها الإصغاء، لا للعالم فقط، بل لصوتها الدفين أيضًا.
السكينة في بحر السرعة
وعلى هذا الأساس، تبقى الكتابة فعل مقاومة، لا بالضجيج، بل بالإصرار على المعنى.
في وجه الاستهلاك السريع، تزرع التأمّل. وفي عالمٍ يركض نحو اللحظة، تختار البطء الجميل، لأنها لا تسعى لجذب الانتباه، بل تُنبت المعنى في صمت.
حين يُغتال الصمت بكثرة النشر
ومع ذلك، تبقى بعض الكلمات شاهدة على قدرة المعنى على اختراق الضجيج. أليست ذاكرة الجسد دليلًا حيًّا، تمامًا كما تكشف الرواية التسجيلية ونوادي القراءة الرقمية عن تعطّش لكتابة تُلامس الوجدان؟ حين تُحوّل الكاتبة ألم المنفى إلى حنين ناطق، فإنها لا تكتفي بالسرد، بل تفتح ثغرة في جدار النسيان.
هكذا تظل الكلمة الصادقة كبذرةٍ عنيدة تنبت بين الصخور، تقاوم المحو. وحين يُغتال الصمت بكثرة النشر، ويفقد الكلام معناه، تصبح الكتابة أكثر أهمية كصوتٍ يقاوم التلاشي.
ما لا تمحوه الحسابات
وفي زمنٍ يلهث فيه كل شيء نحو السطح، تُصرّ الكلمة الحرّة على البقاء، لا كمجرّد صوت، بل كجوهر يُقاوم أن يُختزل في تفاعل، أو يُطوى في لفةٍ خوارزمية.
وتبقى الكتابة تسأل صاحبها بصمتٍ لا يهدأ: هل نكتب لنُنقذ أنفسنا من الضياع، أم لنمنح المعنى لمن لا يجد الكلمات؟
رؤيا تكتب خلاصها
عند جبران خليل جبران، لم تكن الكتابة مجرد مهارة، بل كانت رؤيا، ونافذة يطلّ منها القلب على المطلق.
كان يرى في الحرف قوة خلاص، وفي التعبير الصادق انعتاقًا للروح من قيود الجسد والمجتمع.
كتب في إحدى رسائله: “حين أكتب، أمتلئ وأفرغ في آنٍ واحد، كأنني أطفو بين الصمت والصلاة.”
فالكلمة عنده ليست وسيلة تواصل فقط، بل طريقة للكشف، وممرًّا إلى أعمق ما في الإنسان من نورٍ وظلّ.
الكتابة، إذًا، ليست شكلًا، بل صدى يتردّد في دواخلنا، يربطنا بما هو أسمى من اللحظة، وأعمق من الظاهر.
جرح يحتفظ بحرارته
وهذا ما تؤكّده تجربة الكاتبة اللبنانية هدى بركات، التي استطاعت، في زمن التسارع، أن تزرع المعنى داخل ضجيج الحداثة.
في روايتها “بريد الليل”، حوّلت ألم المنفى والتشظي الإنساني إلى لغةٍ تحتفظ بحرارتها رغم جليد الإيقاع العالمي.
كأنها تقول، دون أن تصرخ، إن الجرح إذا كُتب بصدق، لا يضيع… بل يتحوّل إلى ذاكرة تتقاسمها الأجيال، وتُربّي في النفس حسًّا إنسانيًّا لا يُمحى.
وهكذا تبقى الكلمة الحرّة نارًا صغيرة تُشعل دفءَ الذاكرة في قلب النسيان.
حين تتحوّل الكلمة إلى سلعة
تحت وطأة الاستهلاك الرقمي، لم تعد الكتابة تُناقش، بل تُستهلك بسرعة وتُنسى أسرع.
لم تعد مقاومةً للسطحي، بل مجاملةً له. تحوّل النص إلى منتجٍ يُفصَّل على مقاس الجوائز، لا على إيقاع القلب.
وفي هذا الخراب الرمزي، تظلّ الكتابة الحقيقية فعل عنادٍ هادئ، ومقاومة صامتة، كأنها همس يقول:
التوقف عن الكتابة خيانةٌ للذات، وخذلانٌ لصوتٍ لا يعرف أن يعيش إلا إذا كُتب.
مشروع سيادة لا يُعلَن عنه
ما من أمةٍ كتبت، إلا وصعدت. وما من أمةٍ نسيت الكتابة، إلا وتآكلت من الداخل.
لأن الكلمة ليست زينة، بل سلاح. والفكر ليس ترفًا، بل درع.
والكاتب، مهما كان وحيدًا، يعيد تشكيل الخريطة الرمزية لوطنٍ بأكمله.
ليست المكتبات أماكن للعزلة، بل قواعد خلفية للكرامة. وليست القراءة ترفًا، بل تمرينًا سياديًّا على الاستقلال الرمزي.
وما النهضةُ العربية إلا شاهدٌ حيّ على هذا الأثر العميق للكلمة:
فبينما كان طه حسين يُعيد تشكيل الوعي التعليمي والنقدي في سيرته “الأيام”،
كان جبران خليل جبران يبني بكتابه “النبي” كونًا روحيًّا يلامس وجدان الأمة.
لم تكن كتاباتهم تسجيلًا للتاريخ، بل كانت صناعةً له. ولم يكن حبرهم مجرّد كلماتٍ على ورق، بل دمًا نابضًا في شرايين الهوية.
صراع الوضوح والغمامة
لقد تحوّلنا من زمنٍ كانت الكلمة تبني فيه مصير الأمم، كما في نهضة أقلام مثل طه حسين ونجيب محفوظ، إلى زمنٍ تُختزل فيه المعاني في ومضات رقمية سريعة. لقد انقلبت العلاقة بين الكاتب والعالم: من مشروع جماعي يحمل هموم الناس وأسئلتهم، إلى فعلٍ فرديٍّ منكسر، يُصارع وسط دوّامة الاستهلاك والتكرار.
الإيقاع المكسور في زمن السرعة
في زمن السرعة، تُقذَف الكلمات كالحصى، تُستهلك قبل أن تُفهَم، وتُنسى قبل أن تُعاش. وأمام هذا التلاشي، يحاول الكاتب تثبيت ظلّ فكرة قبل أن تقتلعها رياح النسيان. وهنا، في هذا العبث، تكمن المعجزة: كل جملة صادقة هي تمرّد صامت على جفاف العصر.
وليس من قبيل الصدفة أن هذه التحوّلات تعكس تحديات كبرى في زمن الرقمنة، حيث تُقذَف العناوين في سباقٍ لا يلتفت فيه أحد.
وأمام هذا التلاشي المستمر للمعاني، يقف الكاتب كمن يُمسك بريشة وسط إعصار، يحاول أن يرسم ظلّ فكرة قبل أن تقتلعها العاصفة.
لا وقت للتأمّل، لا مكان للصمت، لا فسحة للعمق. ومع ذلك، في كل جملة تُكتب بإخلاص، مقاومةٌ صامتة لهذا الجفاف.
فالمعنى لا يُقاس بعدد النقرات، بل بمدى ما يوقظه في القارئ من رجع داخلي لا يُرى… لكنه يُحسّ.
الكتابة نسيج الذاكرة الجماعية
وإذا كان هذا هو أثر الكتابة على الفرد، فإنّ أثرها على الجماعة لا يقلّ عمقًا.
الكتابة تصوغ الذاكرة، تحفظ ما لا تستطيع الخطابات الرسمية قوله، وتُعيد رسم ملامح الوطن من زوايا لا تُرى في نشرات الأخبار.
كل نصّ صادق هو خيطٌ صغير في نسيج الهوية الجماعية، وكل قصة تُروى من الهامش هي مقاومةٌ ضد النسيان.
اللقاء السري بين الكاتب والقارئ
ولعل المعجزة تكمن في اللحظة التي يلتقي فيها حبرُ الكاتب بأنفاس القارئ؛
فالنص لا يكتمل إلا حين يُولَد من جديد في وعي من يقرؤه.
هكذا تصير الكتابة حوارًا صامتًا بين غائبين: كاتبٌ يدفن أسراره في السطور، وقارئٌ يحفر ليستخرجها.
من صمت الاستهلاك إلى نَفَس الخلق
وحين تُصبح الكتابة فعلًا يوميًا في حياة الأفراد، تتحوّل المجتمعات من مُستهلكةٍ للمعنى إلى مُنتجةٍ له.
فهي لا تُحرّر الإنسان فقط من صمته، بل تُحرّره من قدرٍ لم يختره…
وتجعله شريكًا في صناعة الحلم، وتشكيل الوعي، والدفاع عن كرامته.
أثر لا يُمحى
لهذا، تظلّ الكتابة، في جوهرها، أعمق من أن تكون حبرًا على ورق.
إنها أثر… وشفاء… وعي يتكاثر كلّما قرأه الآخرون.
الكتابة: البقاء رغم المحو
نكتب لأن الصمت يخنقنا، ولأننا لا نريد أن تُمحى أصواتنا. نكتب لنمنح لحياتنا معنًى وسط هذا الضجيج.
نكتب لأننا نريد أن نترك أثرًا، ولو في ورقة يتيمة على رفٍّ منسي.
الكتابة ليست خلاصًا، لكنها عزاء. ليست حلًّا، لكنها سؤالٌ يوقظنا كلّما هممنا بالنوم على أكفّ العادة.
نكتب ببساطة، لأن من لا يكتب… يُمحى.
سيظلّ الحبرُ دمًا يسيلُ على جبينِ التاريخ، والكلمةُ الصادقةُ سلاحًا لا يصدأ.
لأنّ الكتابةَ في زمنِ المحو هي اليدُ التي ترفعُ حجرًا من جدارِ النسيان، وتقول للعالم:
“هأنذا… وهؤلاءِ هم أنا”.